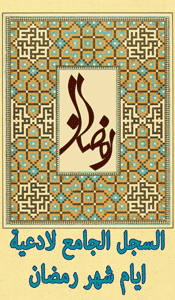الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
المثقفون وضرورة تعميق المعرفة
حين يقارن الدكتور هشام جعيط في كتابه (أزمة الثقافة الإسلامية) بين المثقف الأوروبي والمثقف العربي، يقول عن الأول إنه قد يفصح عن إلحاده أو تشككه، لكنه يقرأ الكتاب المقدس، ولعله قرأ القرآن والبهاغا فاغيتا، والتصوف اليهودي والمسيحي وصار مغرماً بالفكر البوذي والتاوي وهذا ما يكوّن سعة أفقه ويوسع من اهتمامه بالفلسفة اليونانية والتقليد الفكري الحديث من لدن ديكارت. وهذا ليس من شأننا، ـ كما يضيف جعيط ـ بل قلّ من يوجد من قرأ فعلاً موطأ مالك، وصحيح البخاري، والمنقذ للغزالي، وحتى لابن سينا وابن رشد، سوى من اختص في موضوع مستقى من هذه الآثار، لكن ليس بسبب تعميق الثقافة.
هذه الملاحظة الناقدة شديدة الارتباط بنظرة المثقف لذاته، وإلى الدور الذي ينهض به، وإلى مواكبته لحركة المعارف والأفكار المعاصرة والمتجددة، وإلى قدرته على الحضور الحي والفاعل في العالم والعابر للحضارات والمجتمعات المتعددة الثقافات والقوميات واللغات.
المثقف الذي يفترض منه أن يكون وثيق الصلة بالثقافة التي ينتسب إليها ويكتسب صفته منها، هذه الصلة بحاجة إلى تجدد مستدام، لا ينبغي أن تتراجع أو تتوقف، هذا على مستوى التقدير النظري. أما واقع الحال فصورته تختلف، فليس معروفاً عن المثقف العربي إنه مثقف طموح في اكتساب المعرفة، ودؤوب في السعي إليها حتى لو تطلب الأمر تحمل المشاق والصعوبات والعيش تحت ظل ظروف قاسية. لذلك لا نسمع كثيراً عن مثقف سافر بحثاً عن مخطوطة نادرة، أو التحق ببعثة علمية للتنقيب عن حفريات تاريخية ذات قيمة كبيرة، أو اشترك مع فريق بحثي لدراسة قضية تشغل اهتمام العالم. ليست هذه من تقاليد المثقف عندنا، وليست هناك تقاليد ترسخ أو تبعث على هذا النوع من الاهتمام. فالثقافة بالنسبة للمثقف العربي لا تأسر خياله، ولا تمثل له مجداً أو عظمة، وليس على استعداد للتضحية من أجلها وتحمل المشاق في سبيلها. فهي عند البعض مصدر للرزق، وعند آخر وسيلة للمتعة والتسلية، وعند ثالث للوجاهة والهيبة والسمعة، وعند رابع للتفاخر والمجادلة. لكنها ليست للاكتشاف والإبداع والابتكار إلا عند القليل جداً، وليست لتعميق المعرفة وتمثل شخصية المفكر الذي يخاطب العالم ويتواصل مع الإنسانية كافة، ويرفع صوته عالياً في الدفاع عن القيم العليا وفضيلة العلم ونشر الخير ويتمم الأخلاق. إن من أشدّ ما يعترض هذه الرؤية اعتبارها مثالية مستحيلة، أو ضرب في الخيال أو نوع من الطوبى، لأننا لا نتعامل مع أنفسنا بطموحات عالية، ولأن سقف العلم والثقافة عندنا لدرجة من الهبوط يمنع علينا النظر بأفق بعيد، ولغياب النماذج عندنا التي تجسد تلك المصداقية الأخلاقية والإنسانية الرفيعة. أو لأننا غير قادرين على أن نواجه أنفسنا ونتغلب على مشكلاتنا البسيطة أو المستعصية، فكيف نفكر بما هو أبعد من ذلك.
وهذا الذي يجعل من المثقفين العرب لا يقرأون لبعضهم إلا نادراً، ولا تجمعهم إلا المواجهات والمحاكمات، فالنقد يتحول إلى سلطة قمعية، والناقد يصبح مستبداً، والحياة الثقافية يعج فيها التكرار والاجترار والتقليد. التجدد فيها محدود، والإبداع فيها معدود، والاجتهاد فيها ممقوت. والأسماء التي تستحوذ على الاهتمام معدودة للغاية، وكلما صعد اسم جديد تملكه الخوف من إسقاطات الآخرين الذين قد يتربصون به الدوائر من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب.
وعن نفسه يقول هشام جعيط: (كم من مرة اشتهي أن اقرأ للكتاب العرب من المفكرين، فلا أجد زاداً كبيراً مما يمنح تفتح الذهن وإثراء المعرفة ومتعة المطالعة باستثناء القليل القليل. وأنت إذا وجدت جمال الأسلوب، فهو عادة مقرون بسقامة التفكير، وإذا وجدت عمق المعرفة ـ وهو أمر قليل فهو مقرون بثقل الأسلوب).
والمثقف العربي اليوم لا يعتبر مشاركاً في إنتاج المعرفة العالمية والكونية، أو عابراً للقارات والقوميات والثقافات بأفكاره ونظرياته وإبداعاته، ولا يكتسب منزلة علمية وأخلاقية على المستوى الإنساني والعالمي، لتفوقه الفكري أو إبداعه الأدبي، أو لمواقفه الإنسانية النبيلة والشجاعة. فهو لا يطل على العالم إلا من خلال نافذة صغيرة، قد تضيق ولا تتسع، وهي نافذة محيطة وبيئته، ولا يتسع حضوره إلا في دائرة المكان الذي هو فيه والزمان الذي يحتك به. هناك بعض الأسماء لا شك، لكنها على قلتها لا تكاد تذكر ولا تشكل نسبة حقيقية. ففي مجال الثقافة والنقد الثقافي يبرز اسم إدوارد سعيد وفي مجال الأدب والرواية يبرز نجيب محفوظ وفي مجال العلم والكيمياء يبرز أحمد زويل وفي مجال تاريخ العلوم وفلسفته يبرز رشدي راشد.
لذلك فإن المثقف العربي بحاجة لأن يغير هذه الصورة عن نفسه، ويبتكر لذاته طموحاً عالياً، ويجتهد في تعميق المعرفة وتطويرها المستدام، ويتحول إلى داعية يتمسك بنزعته الإنسانية والأخلاقية، ويتسع نظره إلى العالم والناس كافة، فالمعرفة لا حدود لها من حيث المكان والزمان، والثقافة لا جدران لها ولا سقوف، فهي التي تجعل من الإنسان أن يكون كونياً. ويرى إدوارد سعيد بأنه (لا وجود البتة لمن يمكن وصفه بمثقف خاص، لأنك تدخل العالم العام منذ اللحظة التي تكتب فيها كلماتك ثم تنشرها). ويرى مالك بن نبي إن (المثقف المسلم نفسه ملزم بأن ينظر إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية الرحبة، حتى يدرك دوره الخاص، ودور ثقافته في هذا الإطار العالمي). وقد جاءت العولمة لكي تفرض على المثقف في أن يكون كونياً، وينظر لذاته ودوره من زاوية عالمية، المهمة التي تؤكد عليه تعميق المعرفة1!
- 1. موقع الاستاذ زكي الميلاد ـ الوطن ـ الثلاثاء 14 أغسطس 2001م، العدد 319.